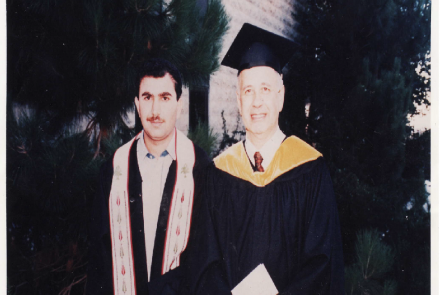أنا اليوم أردُّ العطاء
اسمي عدنان حمّاد، تخرجت من جامعة بيرزيت في السنوات الأولى لتحولها إلى جامعة، وقد دخلتها في العام 1978 وتخرجت منها عام 1983، كانت رحلة الجامعة في ذلك الوقت مليئة بالتحديات، فقد تم إغلاق الحرم الجامعي القسري بسبب الاحتلال لمرات عدة حينها.
عدد طلبة الجامعة في تلك الفترة كان لا يتجاوز 500 طالبة وطالب، وكان العديد من الطلبة يأتون من طبقة غنية مادياً، ولكن البعض منا يأتون من واقع اقتصاديّ صعب، فأنا مثلاً من مخيم قلنديا للاجئين، وهناك أتممت سنواتي الدراسية الأولى، وكانت المرات الأولى لي لدخول المدن الكبيرة كالقدس ورام الله بعد أن أنهيت الصف السادس الابتدائي. أتذكر جيداً حين انهيت امتحان "المترك" كنت أرى باص جامعة بيرزيت الأصفر يمر من طريق قلنديا وأنا في طريقي إلى مدرسة رام الله الثانوية، وكلما رأيته اعترتني فكرة الذهاب إلى هذه الجامعة مستقبلاً. متحدياً نفسي بأنني سأكون طالبها يوماً ما.
أنهيت دراستي الثانوية، والتحقت بالجامعة، وكان أحد شروط الالتحاق هو تقديم امتحان اللغة الإنجليزية والذي تفوقت فيه، مما جعلني اتخطى المواد التأسيسية في اللغة والتي كانت من المتطلبات الجامعية، مما دفع العديد من زملائي إلى التساؤل كيف فعلت ذلك.
كان عدد الطلبة من مخيمات اللجوء حينها لا يتجاوز الخمسة طلاب. وفي ذلك الوقت لم يكن لدينا المقدرة على تغطية تكاليف أقساطنا الفصلية، والتي كانت تكلّف حينها ما يقارب 55 ديناراً، وهو مبلغ ليس بالبسيط آنذاك، لذلك قمت بالتقديم للعديد من المؤسسات التي تقدم دعماً للطلبة مثل جمعية إنعاش الأسرة وجمعية مخيم قلنديا، واليتيم العربي وغيرها من المؤسسات، وكنت أحصل منها على منح جزئية، فأذكر جيداً أن قيمة إحدى المنح كانت أربعة دنانير، وثانية تغطي ثمانية دنانير، ومبالغ قليلة أخرى. مما حتّم عليّ حينها العمل في ورش البناء في نهاية كل أسبوع، وكذلك العمل في الجامعة بعد انتهاء الدوام الجامعي، إلا أنّ كل ذلك لم يثنيني عن المشاركة في الأنشطة الجامعية المختلفة. حيث كانت بيرزيت في ذلك الوقت قائدة في صناعة القرار الفلسطيني، وشعلة لحرية الشعب الفلسطيني.
تخرجتُ من الجامعة التي قضيت فيها أفضل سنوات حياتي حتى الآن، وما زلت أذكر نشاطاتي في الجامعة ومشاركتي في مجلس طلبتها، فكنت مسؤولاً عن لجنة التخصصات في المجلس، وأذكر جيداً العمل التطوعي الذي قمنا به من قطف للزيتون في القرى الفلسطينية المختلفة، إلى دهن الأرصفة والشوارع، وبرامج محو الأمية وغيرها الكثير، وأستطيع القول أنّ جامعة بيرزيت هي الرائدة في ترسيخ العمل التطوعيّ في الوطن. وقد درس معي وكان نشيطاً في حينها د. غسان الخطيب والذي استمرت علاقتي معه إلى الآن، هذه العلاقات التي تكونت في تلك الفترة كانت سبباً لاستمرار تواصلي مع الجامعة.
أتذكر الحرم القديم جيداً، وكيف في كل ليلة كنا نتجمع للدبكة، وكان يشاركنا الحراس أيضاً ولم نشعر قط بالتعب، وهناك ذكرى أخرى أحملها معي دوماً وهي د. جابي برامكي، الذي كان رئيساً للجامعة وفي نفس الوقت يتعلم منا دون أن يشعرنا أن هناك فرق بيننا، فأبوابه كانت دائماً مفتوحة لنا. كان دوماً يقف في وجه قوات الاحتلال عند اقترابهم من الجامعة وطلبتها، كنا كطلبة مندفعين جداً، لكنه لم يكن يوماً يردعنا أو يلومنا على إغلاق الحرم الجامعي، بل على العكس، كان داعماً لنا فخور بنا.
انتقلت إلى المملكة المتحدة بعدها لأنهي دراستي في الماجستير بتخصص علم النفس السريري، وهناك تواصلت معي دكتورة فتحية نصرو رحمها الله وقد كنت أحد طلبتها، وعرضت عليّ العمل معها وقد درّست علم النفس السريري وعلم النفس المجتمعي في الجامعة لمدة عام، لتسنح لي الفرصة بعدها باستكمال دراستي للحصول على درجة الدكتوراه في علم الأوبئة والصحة العامة، حيث عرض عليّ أن أكون مديراً إدارياً لمستشفى المقاصد بشرط استكمال تعليمي في هذا المجال، وعدت بعد استكمال شهادتي في المملكة المتحدة للعمل في المستشفى لعدة سنوات، تقاطع فيها عملي مع جامعة بيرزيت في عدة مناسبات، لأتعرف على أجيال متلاحقة من الطلبة واتابع تطور الجامعة عن كثب. انتقلت بعدها إلى الولايات المتحدة، وأكملت حياتي المهنية هناك.
في الولايات المتحدة أوكل إلى دور هام في وقت كانت فيه السلطة حديثة العهد في البلاد وتحاول تعزيز علاقتها مع الجالية الفلسطينية في كل مكان، وهو مسؤول ملف الصحة العامة والخدمات الطبية للجالية العربية في ميشيغان، وهناك أدركت أهمية العطاء، لذلك كنت دائماً أركز على أن أتبرع بجزء من دخلي للمحتاجين وبعض المؤسسات التي تساهم في العطاء للمجتمع. وما ساعدني أكثر هو ثقافة العطاء المحفِزة في الولايات المتحدة، مثل الإعفاءات الضريبية، ومشاهدة أثر العطاء بشكل مباشر. واليوم أنا أُعد من أفضل 5% من الباحثين في المجال الصحي في الولايات المتحدة. وأعمل كرئيس لهيئة عالمية تختص في البحوث والحلول الصحية، وأركز على العطاء كجزء أساسي من حياتي.
كانت وما تزال حياتي المهنية حافلة، من تأسيس لمركز ACCESS للصحة المجتمعية والبحوث، للتدريس في جامعات عدة وتعليم مواد الصحة والأبحاث الصحية، كما أنني أعمل مع العديد من المؤسسات البحثية ولي أكثر من 200 منشور في مجالات البحث السلوكي والوبائي، وعدة فصول في كتب تتضمن علم نفس الصحة العربي، واختلافات الصحة بين العرب الأمريكيين، وسوء الاستخدام للمواد الكيميائية، وغيرها من المواد البحثية. حصلت على العديد من الجوائز، وكان أهمها، جائزة الخدمة المتميزة من الجمعية الوطنية للأطباء العرب الأمريكيين (NAAMA) في نيسان علم 2016، وجائزة ACCESS Lifetime للخدمة المجتمعية في كانون الأول عام 2014، وجائزة سانت جورج الوطنية من جمعية السرطان الأمريكية في عام 2012، وجائزة الإنسانية الوطنية في عام 2009. كما حصلت أيضاً على جائزة مسارات في الطب من مدرسة طب جامعة واين ستيت في عام 2004، وكنت أول عربي أمريكي يتم تكريمه بهذه الجائزة نظراً لمبادرتي القيادية في تعزيز وتحسين وضع الصحة لدى الجالية العربية الأمريكية.
كانت بيرزيت بالنسبة لنا مثل الأم التي لا نستطيع الابتعاد عنها، ومنذ تخرجي أدركت أن عليّ أن أرد جزءاً من العطاء، وقد كنت أزور فلسطين بين الفنية والأخرى، حتى تواصل معي د. جميل أبو سعدة وطلب مني أن أكون جزءاً من العطاء للجامعة وأن أساعد الطلبة غير المقتدرين فيها. فبدأت بتبني طالب/ة جامعي/ة يدرس في الجامعة طوال سنوات تعليمه/ا، وكنت أركز على اللاجئين، وعلى الطالبات، وعلى المتفوقين في الثانوية العامة، وأهم من ذلك كله، من لديهم روح العطاء مستقبلاً، لذلك عادة ما أضع سؤالاً عند اختيار الطلبة، بأن هل لديهم الاستعداد للعطاء لطلبة آخرين مستقبلاً لمساعدتهم على إنهاء دراستهم في الجامعة؟ من أجل ضمان استمرار هذا الأثر. فمثلاً أذكر إحدى الطالبات اللاجئات التي درست في كلية الهندسة والآن تتبوأ منصباً هاماً في إحدى الوزارات، وقد بدأت رحلة مع طالبة أخرى حالياً لمساعدتها في تعليمها والتي تتخصص في علاج النطق والسمع.
تغمرني السعادة عند العطاء للجامعة، ومساعدة طلبتها، وأنظر إلى هذا الدعم كجزء أساسي من دخلي يوازي إنفاقي على الطعام، الذي لا أستطيع الاستغناء عنه. وأتعامل مع هؤلاء الطلبة بمسؤولية كأنهم أبنائي. وفعلاً قمت بإرسال اثنين من أبنائي لتعلم اللغة العربية في جامعة بيرزيت، تعلقاً منهما بالجامعة، فقد كانت حكاياتي عن الجامعة حديثاً رئيسياً على طاولة العشاء للعائلة، فنما بداخلهما حبٌ لها وإصرار على القدوم للعيش والتعلم في أحضانها. وعندما سنحت الفرصة، لم يترددا.
أمنيتي اليوم أن يقوم كل خريجٍ من خريجي الجامعة برد جزء من العطاء لها، ولو قام كل خريج بتبني طالبٍ محتاج، فلن يكون هناك طلبة محتاجين ولن يكون العائق المادي سبباً لحرمان أحدهم من التعليم. وعلينا العمل سوياً كخريجين مع الجامعة من أجل ضمان ازدهارها، وبناء جسور للعطاء مع الجامعة. أما رسالتي للخريجين الجدد، كونوا رياديين، لتكونوا ناجحين، لتصنعوا بعدها أثراً لكم وللمجتمع وللجامعة.