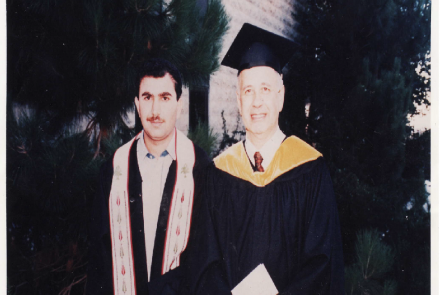النجاح قرار وليس خياراً.. مهما كانت الظروف-علي نصر
انتهت للتو امتحانات الثانوية العامة، صيف عام 1991، كان طلاب التوجيهي المنهكون من مسيرة 12 عاماً من الدارسة المتواصلة، يأخذون استراحة المحارب لبعض الوقت، بانتظار النتائج، والتخطيط، ورسم ملامح المستقبل للمرحلة القادمة. أسئلة كثيرة كانت تدور في أذهان الطلبة وذويهم: "هل سأنجح؟ وكيف سوف أبرر الفشل لعائلتي؟ ما هي العلامة المتوقعة؟ أي الجامعات سوف أرتاد؟ ما هو التخصص المناسب لي؟".
بالنسبة لي، بدأ التخطيط مبكراً، وكان السؤال الجوهري: من أين لي بمصاريف الدراسة؟ وكيف أستطيع تأمين الأقساط الدراسية؟ فالأسئلة الأولى التي كان يتداولها الطلبة كانت قد نضجت لدي في موعد مبكر، فخطتي كانت دراسة الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت. وكنت على يقين بأن علامة الثانوية العامة سوف تتيح لي ذلك.
كان تأمين فرصة عمل داخل الخط الأخضر لبعض الوقت هو الجواب الأمثل عن سؤالي، وهو الطريق الذي يجب أن أمر عبره للالتحاق بالجامعة وتحقيق حلمي بأن أكون مهندساً ورياديّاً، وكان ذلك متاحاً فعلاً، فقد كان عملاً شاقّاً يعتصر العرق حتى من الأحشاء، هناك في مدينة بئر السبع التي تتميز بالصيف الصحراوي الحارق. لم يخالجني أي شك أو تردد، ولم يتسلل إلى أعماقي أي إحباط أو وجل. كان طموحي يشحنني.
بدأ التسجيل للجامعات وبدأ زملائي خريجو الثانوية العامة بحجز مقاعدهم للفصل الأول في الجامعات المختلفة، ولم أتمكن حينها من جمع القسط ومصاريف الدراسة للعام الأول. قررت بكل ألم، ولكن بكل إصرار، تأجيل الالتحاق بالجامعة عاماً لجمع مصاريف كافية للأقساط والمصاريف الدراسية، وكان هذا اللهيب الصحراوي يلفح وجهي كعامل بناء يطمح لكي يكون مهندساً. وكان يشحنني باستمرار.
مر العام وأنا أحشد ما أمكن من الطاقة والمادة لكي ألتحق بجامعة بيرزيت. وفعلاً قدمت الطلب اللازم وأتممت إجراءات التسجيل. وجاء التحدي الأول مبكراً، حيث تم قبولي في كلية العلوم وليس كلية الهندسة التي أردت. لم تكن كلية العلوم في سلم طموحاتي، فبحثت عن كافة الطرق الالتفافية التي تعيدني إلى كلية الهندسة، وأثلج صدري أن القانون الجامعي يتيح لي ذلك بعد السنة الدراسية الأولى، إذا كان تحصيلي في مادتي الرياضيات والفيزياء أعلى من 80%، كانت هذه فرصتي الوحيدة، وقد تشبثت بها بكل ما أوتيت من قوة، وكنت أدرس بشكل متواصل لكي أتجاوز المعدل المطلوب. كانت علاماتي مفاجئة للعميد، وتجاوزت الـ 90%، ما حدا بعميد كلية العلوم لإغرائي للبقاء في الكلية، ولكنه اصطدم بإصراري العجيب على الالتحاق بكلية الهندسة، ولم يملك سوى توقيع "تذكرة" دخولي للكلية وأنا ظافر منتصر.
مضت فترة الدراسة، بجماليتها المفرطة، وتجربتها الفريدة. لم تمر هذه السنوات الخمس برخاء، وإنما اعتدت على العمل في العطل الصيفية وأحيانا أيام العطل الأسبوعية لتأمين المصاريف المطلوبة، حيث كان أبي -رحمه الله-يمدني بكل ما يستطيع ادخاره كفلاح بسيط يدخر مما تنتجه الارض، لم تتسنَ له رؤيتي أتخرج من الجامعة، كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى خلال السنة الدراسية الرابعة، حيث خيم علي الحزن الشديد للسنة المتبقية. واخترت أن أشارك في حفل التخرج دون دعوة أي من أفراد العائلة، ولا حتى أمي، حيث كان أملي أن يكون والدي على مقاعد العائلات يحقق أمنية انتظرها طويلاً، ويرى ابنه يصافح الأساتذة المتواجدين على المنصة أثناء تسلم شهادة التخرج. لقد كرر هذه الأمنية على مسامعي طيلة مدة الدراسة، وانتظرها بشغف.
بدأ مشوار الحياة الفعلي، وكانت الفرض غير متاحة بقدر ما انتظرت، ولكنني كنت متخفزاً لالتقاط الفرصة المناسبة، وبدأت مشواري المهني مهندساً للأعمال المدنية في شركة الاتصالات، خريف عام 1997م. كان العمل في مقر الشركة في رام الله، كان الراتب الأول بمثابة مكافأة صبر وإصرار استمر طوال 18 عاماً من الدراسة، وهرولت به مسرعاً لكي أرد بعض الجميل للعائلة، وأشتري ما أمكن من احتياجات المنزل. عائلتي كبيرة، من 8 إخوة وأختين، وكان معظمهم قد ارتاد الجامعة في فترات متقاربة، وكان منهم من يعمل ويساهم في تعليم الآخرين. كانت العائلة متكاتفة في كل المناحي الاجتماعية والمالية. وهذا بلا شك عنصر من عناصر النجاح.
لم يطل مشواري الوظيفي، كان لعامين، وكان كافياً لي لاستكشاف الآفاق الممكنة. في نهاية عام 1998، قمت بتسجيل شركة خاصة "شركة الإخوة" مع أشقائي، وباشرت العمل كمقاول لدى شركة الاتصالات التي استقلت منها للتو. وتطور العمل في الشركة وتنوعت الخبرات، ومع تطور الخبرة ورأس المال التشغيلي، بدأت الشركة في دخول مجالات الإنشاءات الأخرى من مبانٍ عامة، وبنية تحتية، وأصبحت مصنفة درجة أولى في معظم المجالات. ونظراً لأن السوق الفلسطينية صغيرة نسبيّاً، فقد كانت عندي رؤية للتوسع الأفقي من خلال إنشاء استثمارات أخرى، وألا يقتصر العمل على مجال المقاولات فقط، وقمنا فعلاً عام 2008 بإنشاء مصنع لإنتاج الأنابيب المعدنية المعزولة، التي باتت تستعمل في كل مشاريع المياه في فلسطين. كان هذا الاستثمار بمثابة تحدٍّ لسطوة المحتل واحتكاره للسوق الفلسطينية. وكان ما واجهناه من صعوبات يمثل تجربة تجسد الوجه القبيح للمحتل في محاولة فرض التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، ولا سيما للسلع السيادية. كان هذا الاستثمار، ورغم معيقات المحتل في إدخال الماكينات والمواد الخام وقطع الغيار، هو تجربة ناجحة بامتياز، جعلت فلسطين تنتج هذه السلعة، لا بل وتصدرها للدول المحيطة أيضاً. كانت هناك استثمارات أخرى متعددة، منها استثمارات في مجال البنية التحتية للمياه والطاقة "شركة سما"، واستثمارات تتعلق بإنشاء خطوط إنتاج جديدة، ومحطات للطاقة الشمسية. وانطلقنا من أن الطريق إلى التحرر يمر عبر إنشاء اقتصاد فلسطيني مقاوم، قادر على التحلل من التبعية، ولو جزئيا، من اقتصاد المحتل وأجنداته. إن خلق أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 500 فرصة عمل غير مباشرة يجعل من هذه المحاولة مصدر فخر.
بالتزامن مع الاستثمار وتطوير قطاع الأعمال، طورت مجموعة الشركات أيضاً منظومة اجتماعية تنطلق من مسؤولية المجموعة المجتمعية التي تسعى بموجبها إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة. فقد تبنت الشركة برامج لتدريب الخريجين وفتح فرص لاستيعابهم، واستيعاب طلاب ضمن برامج أكاديمية، وكذلك تخصيص ميزانية سنوية، وذلك لتمكين العائلات الفقيرة، حيث تم تبني مبادرة "عائلات منتجة"، وهي مبادرة تمولها وترعاها المجموعة.
لجامعتي بيرزيت، ولأساتذتي الذين أحببت، ولزملائي في الدراسة جميعهم، أعبر عن مدى امتناني وشكري العميق. بيرزيت كانت وبحق حاضنة حقيقية، تعمل على إعادة صياغة وصقل شخصية الطالب، وتغرز فيه مفاهيم تتعلق بالانتماء، والوطنية، والصدق، والأمانة. بيرزيت، لا تغذي المخزون العلمي للطالب وحسب، وإنما تعزز المخزون الثقافي والمجتمعي، وتخلق من الطالب شخصية متكاملة ريادية، قيادية، تستطيع أن تمخر عباب الحياة بكل ثقة وصلابة، ونجاح.
لبيرزيت العريقة مني سلام.